
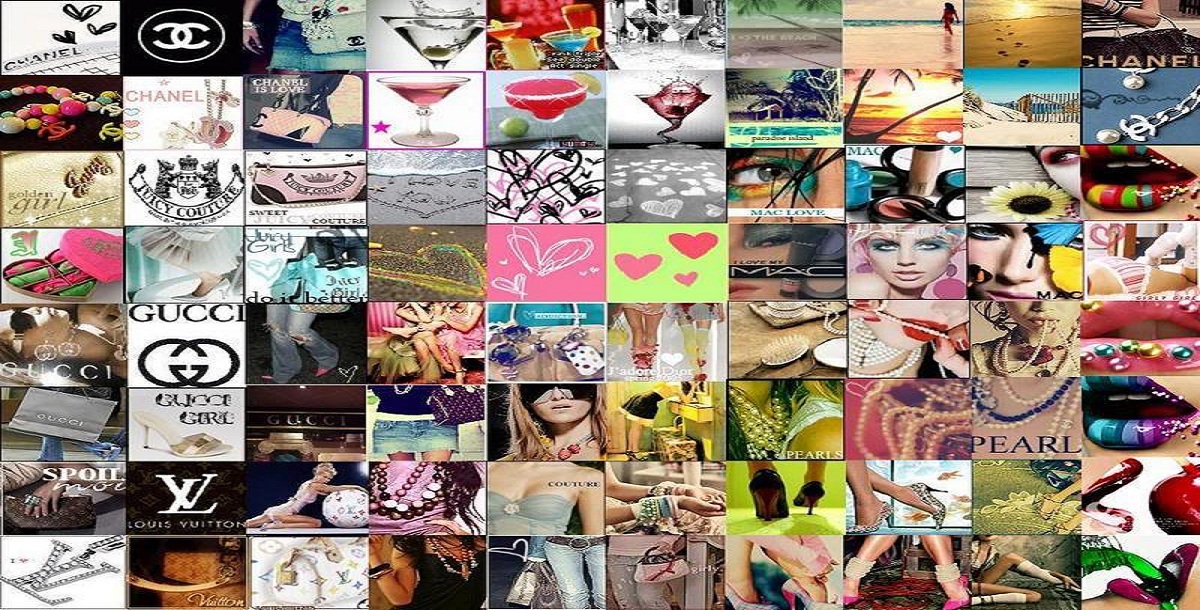
في ظل التطور الاقتصادي الكبير الذي لاحت بوادره مطلع القرن الماضي، والتطور الصناعي الذي نتجت عنه زيادةٌ ملحوظة في كمية الإنتاج، كان لا بدّ لشركات التسويق الكُبرى من ابتكار استراتيجيّاتٍ متعدّدة، لزيادة نسبة مبيعاتها وترسيخ سوقٍ جديدةٍ من السلع الاستهلاكيّة للزبائن، وهنا ظهرت فكرة "البراندات" أي الماركات العالميّة، والتي نجحت في ترويج السلع المترفة مثل الساعات والحقائب والأحذية والملابس والمجوهرات وغيرها من الماركات العالميّة، وكان المخطط الشرير لشركات التسويق، أنها عمدت إلى ربط اقتناء تلك الماركات بالبريستيج الاجتماعي، فزاد الطلب عليها مما أدى إلى ارتفاع سعرها أضعافاً عما هو في الحقيقة.
والغريب أنه رغم ارتفاع سعرها بشكل غير منطقي، يستمر الطلب عليها بالازدياد، فمثلاً هناك لوائح انتظارٍ طويلة على حقيبة "هيرميس" الشهيرة، لدرجة أن دار هيرميس قامت في عام 2008 بإيقاف الطلبات، لعجزها عن تحمّل ضغط المزيد من الإنتاج، على الرّغم من أن متوسط سعر تلك الحقيبة يصل إلى 9400 دولار!
يقولُ خبراءُ الاقتصاد إنّ هناك سلعاً باهظة الثمن يشتريها الناس لثمنها الغالي، ولو رخصت لتوقّفوا عن شرائها، فلو خفّضت ماركة عالميّة من ثمن أحذيتها، لتوقف الناس عن شرائها ولو أُغرقت الأسواق بنظارات "برادا" لما تهافت النجوم على اقتنائها، فهي لم تعُد توحي بالتّميُز بعد أن أصبح بإمكان الكثيرين امتلاكها، فالنّظارةُ بالنسبة لهم ليست فقط للوقاية من أشعة الشمس، إنما في الدّرجة الأولى للتباهي باسم المصمم وفخامة الماركة!
وأكثر من ذلك، فقد دأبت شركات التسويق الكبرى على البحث المستمر لاقتناص الفرص التي تمكنها من تنفيذ استراتيجياتها التسويقية، وجاء الإنترنت بعد فترةٍ من الزّمن ليزيد الطّين بِلّة، حيث أعطاها فرصةً ثمينة لـ "عولمة تسويقها" للماركات، فما كان محصوراً ببلدٍ واحد أو بعدّة دولٍ متجاورة، أصبح منتشراً على نطاقٍ عالمي، وزاد الطلب عليه أكثر فأكثر، لينتشر وباءُ الماركات حتى في الدّول الفقرة والنّامية.
كما نلاحظ في أيامنا هذه إذا دخلنا أحد المولات الكبيرة، أنَّ هناكَ مدخلاً خاصاً للماركات التي تصطف بجانب بعضها، حتى أنهم يمّيزونها بالأضواء المُبهرة و رائحة العطور الفاخرة لجذب الشباب والشابّات، دون أن نرى عبارةً واحدة لتوعية الشباب وإقناعهم بضروة اقتناء الأجود والأنسب لهم ولميزانياتهم، وليس ما يحقق لهم البريستيج الفارغ أمام المجتمع.
والواضح أن هوس النساء باقتناء الماركات أقوى منه لدى الرجال، حيث أن الشراء بالنسبة لبعضهن لم يعد للحاجة أو للذوق الاجتماعي، بل تعدّاها لمرحلة المباهاة والتقليد، وهذا مردّه في الغالب إلى شعورٍ بالنّقص، وحاجةٍ إلى لفت الانتباه وخاصّةً لدى الشخصية "الهستيريّة" وهي السّريعة التاثر بالأحداث اليوميّة والأخبار المثيرة.
ولكن الجديد هو دخول الأطفال في هذا المجال كمستهلكٍ مُستَهدف، حيث أصبح هناك ماركات متخصصة بألبسة الأطفال وحاجياتهم، ولما كان من الصّعب أن يفرّق الطفل بين ما هو ماركة وغيرها، فمن الواضح أنّ الأهل هم من يزجّون أطفالهم في هذه المعمعة لزيادة التباهي، دون أن يدركوا الأثر السّلبي المخيف الذي سينتج عن ذلك.
فالطفل يكبر وهو يرى ويسمع ويخزّن ردود فعل الكبار وانطباعاتهم، ويكوّن مفاهيمه وآراءه من خلالها، فإذا نشأ على ارتداء ماركة معيّنة يصبحُ من الصّعب إرضاؤه بمستوى أقل في المستقبل، كما أنه لا شعوريّاً يتكوّن لديه ولاءٌ لتلك الماركة، ويبدأ بتصنيف الأطفال الآخرين من حوله على هذا الأساس، ليُشكِّل فريقاً مع من يرتدونها، ويُقصي الآخرين ممن لا يملكون القدرة على امتلاكها.
ومن ناحيةٍ اُخرى يؤكّد علماء النفس أن الأطفال الذين لا يملكون القدرة على امتلاك الماركات يتكوّن لديهم شعورٌ دفين بالاضطهاد والدّونيّة والحزن، كردّة فعلٍ على طريقة تعامل "أطفال الماركات" معهم، والأمر من الخطورة بحيثُ أنه لا يخلق جوّاً من التوتّر بين الأطفال على المستوى النفسي فقط، بل يقلبُ المفاهيم الصحيحة لدى الطفل ويخلط أولوياته، ويخفّض من قدرته على اتخاذ القرار والاختيار بين ما هو جميل وما هو غير جميل، ويغير مفهوم ما هو "أخلاقي" في عالم الطفولة.
والمؤسف حقاً هو مساهمة المشاهير في ترسيخ فكرة ماركات الأطفال، حيث نراهم ينشرون عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعية صوراً لأطفالهم وهم يرتدون أشهر الماركات العالميّة الباهظة الثمن، مما جعل الجمهور ينقسم بين متأثّرٍ ومقلّد وبين مستهجنٍ من تلك التصرفات السطحية والمستفزة، خاصّةً في ظلّ الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة وتفشي البطالة، وعلى الرّغم من كلّ ذلك فإن عدد متتبعيهم على التويتر يثبت أن ثقافة الاستهلاك هي السائدة، حتى لو لم نتقبلها.
فهل نملك القدرة على الوقوف ضدّ التيّار لنعلّم أنفسنا وأطفالنا النظر أبعدَ من أسماء الأشياء؟!












